 الإهداءات الإهداءات | |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
 الإهداءات الإهداءات | |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #36 |
         | أهداف درس الإملاء من كتاب الإملاء والترقيم في الكتابة العربية لعبد العليم إبراهيم لا جدال في أن تحديد الهدف لكل عمل، يساعد على اختيار أنجح الوسائل الكفيلة بتحقيق الغاية من هذا العمل، في سرعة وسهولة، ومن أهداف درس الإملاء: 1- تدريب التلاميذ على رسم الحروف والكلمات رسمًا صحيحًا مطابقًا للأصول الفنية، التي تضبط نظم الكتابة أحرفًا وكلمات. 2- تذليل الصعوبات الإملائية التي تحتاج إلى مزيد من العناية: كرسم الكلمات المهموزة أو المختومة بألف لينة، أو الكلمات التي تتضمن بعض الحروف القريبة أصواتها من أصوات حروف أخرى، لا يميز بينها غير التفخيم والترقيق ونحو ذلك، مثل: السين والصاد والثاء، ومثل: الذال والزاي والظاء. وتزداد هذه الصعوبة إذا اجتمع في الكلمة الواحدة حرفان متقاربٌ صوتاهما، أو مختلفان ترقيقًا وتفخيمًا مثل: صوت وسوط ووسط، مثل: يتطلع، ويتطلب، ومثل: يصطدم ويصطنع، ومثل: يزداد، ونحو ذلك، ومثل الكلمات التي تتوالى فيها أحرف من فصيلة واحدة في الكتابة، مثل: الباء والتاء والثاء والنون والياء في مثل: ثبت، بيت، نبت، يثبت، يتثبت، ومثل: مصر، مطر، يصبر. 3- الإملاء فرع من فروع اللغة العربية، وللغة عدة وظائف، تدور حول الفهم والإفهام، ومن أهداف الإملاء أن يسهم في هذا الجانب، بأن يزيد في معلومات التلميذ، بما تتضمنه القطعة من ألوان الخبرة وفنون الثقافة والمعرفة وبأن يقدره على تصوير ما في نفسه، مكتوبا كتابة سليمة، تمكن القارئ من فهمه على وجهه الصحيح. 4- ومن أهداف دروس الإملاء تجويد خط التلاميذ، وإذا بكّر المدرسون برعاية هذا الهدف، خفت مشكلات كثيرة ثقيلة، تنشأ عن رداءة خطوط الطلاب الكبار والعاملين في الدواوين والمؤسسات. 5- درس الإملاء: يتكفل بتربية العين عن طريق الملاحظة والمحاكاة في الإملاء المنقول، وتربية الأذن بتعويد التلميذ حسن الاستماع، وجودة الإنصات، وتمييز الأصوات المتقاربة لبعض الحروف، وتربية اليد بتمرين عضلاتها على إمساك القلم، وضبط الأصابع، وتنظيم تحركها، وهكذا. 6- وإذا اعتبرنا الهدف السابق من الأغراض الفسيولوجية وما قبله من الأغراض التعليمية، فهناك أغراض أخرى تتصل بالنواحي الخلقية والذوقية، مثل: تعويد التلميذ النظام والحرص على توفير مظاهر الجمال في الكتابة وبهذا ننمي فيه الذوق الفني. 7- ومن الأهداف اللُّغوية لدرس الإملاء إمداد التلميذ بثروة من المفردات والعبارات، التي تفيده في التعبير، حديثا أو كتابة. ومن هذه الأهداف يتبين لنا أن درس الإملاء يتكفل بتحقيق أغراض جليلة: تربوية، وخلقية، وفنية، ولُغوية. منزلة الإملاء بين فروع اللغة: 1- للإملاء منزلة عالية بين فروع اللغة؛ لأنه الوسيلة الأساسية، إلى التعبير الكتابي، ولا غنى عن هذا التعبير، فهو الطريقة الصناعية، التي اخترعها الإنسان في أطوار تحضره؛ ليترجم بها عما في نفسه، لمن تفصله عنهم المسافات الزمانية والمكانية، ولا يتيسر له الاتصال بهم عن طريق الحديث الشفوي. وإذا كانت القواعد النحْوية والصرفية وسيلة إلى صحة الكتابة، من النواحي الإعرابية والاشتقاقية ونحوها، فإن الإملاء وسيلة إليها، من حيث الصورة الخطية. ونستطيع أن ندرك منزلة الإملاء بوضوح، إذا لاحظنا أن الخطأ الإملائي يشوه الكتابة، وقد يعوق فهم الجملة، كما أنه يدعو إلى احتقار الكاتب وازدرائه، مع أنه قد يغفر له خطأ لُغوي من لون آخر. أما بالإضافة إلى التلاميذ، في المراحل التعليمية الأولى، فالإملاء مقياس دقيق للمستوى التعليمي الذي وصلوا إليه، ونستطيع -في سهولة- أن نحكم على مستوى الطفل، بعد أن ننظر إلى كراسته، التي يكتب فيها قطع الإملاء. عوامل التهجي الصحيح: يرتبط التهجي الصحيح بعوامل أساسية، بعضها عضوي، كاليد والعين والأذن، وبعضها فكري: أما اليد: فهي العضو الذي يعتمد عليه في كتابة الكلمة، ورسم أحرفها صحيحة مرتبة، وتعهد اليد أمر ضروري لتحقيق هذه الغاية؛ ولهذا ينبغي الإكثار من تدريب التلميذ تدريبًا يدويًّا على الكتابة؛ حتى تعتاد يده طائفة من الحركات العضلية الخاصة، يظهر أثرها في تقدم التلميذ وسرعته في الكتابة. وأما العين: فهي ترى الكلمات، وتلاحظ أحرفها مرتبة وفقا لنطقها؛ وهي بهذا تساعد على رسم صورتها صحيحة في الذهن، وعلى تذكرها حين يراد كتابتها. ولكي ننتفع بهذا العامل الأساسي، في تدريس الإملاء يجب أن نربط بين دروس القراءة ودروس الإملاء، وبخاصة مع صغار التلاميذ، وذلك بأن يكتبوا في كراسات الإملاء بعض القطع التي قرءوها في الكتاب، أو جملًا قصيرة، يكتبها المدرس على السبورة، أو تعرض عليهم في بطاقات، وهذا يحملهم على تأمل الكلمات بعناية، ويبعث انتباههم إليها، ويعود أعينهم الدقة في ملاحظتها، واختزان صورها في أذهانهم، وتتحقق هذه الغاية في فترات القراءة الجهرية وبصورة أوفى في فترات القراءة الصامتة. وينبغي أن يتم الربط بين القراءة والكتابة في حصة واحدة، أو في فترتين متقاربتين؛ أي قبل أن تمحى من أذهان الأطفال الصور التي اختزنوها. كما ينبغي أن نعرض الكلمات الصعبة، والكلمات الجديدة على السبورة فترة من الزمن، ثم نمحوها قبل إملاء القطعة؛ لنهيئ للعين فرصة كافية لرؤية الكلمات، والاحتفاظ بصورها في الذهن. وأما الأذن: فهي تسمع الكلمات، وتميز مقاطع الأصوات وترتيبها، وهذا يساعد على تثبيت آثار الصور المكتوبة المرئية؛ ولهذا يجب الإكثار من تدريب الأذن على سماع الأصوات، وتمييزها وإدراك الفروق الدقيقة، بين الحروف المتقاربة المخارج، والوسيلة العملية إلى ذلك هي الإكثار من التهجي الشفوي لبعض الكلمات قبل كتابتها. العوامل الفكرية: أما العوامل الفكرية التي يرتبط بها التهجي الصحيح، فتقوم على ما حصله التلاميذ من المفردات اللغوية، في مجالات القراءة والتعبير، ومدى قدرتهم على فَهْم هذه المفردات، والتمييز بين معانيها، ومدى ملاءمتها لسياق الكلام، ويظهر أثر هذا الوعي اللغوي في اتقاء الأخطاء اللغوية، التي يقع فيها كثير من التلاميذ، في كتابة أمثال هذه الكلمات: أذهان، مراعاة، لا يتسنى له، المدرسة الثانوية، يختلط، يصطدم، فهمت كل ما قلته، إذ يكتبون هذه الكلمات بترتيبها السابق: أزهان، مراعات، لا يتثنى له، المدرسة السنوية، يخطلط، يسطدم، أو يصتدم، أو يصطضم، فهمت كلما قلته ... وهكذا، فلاشك أن هذا الخطأ مرده إلى ضعف المحصول اللغوي والعجز عن إدراك ما يتطلبه سياق الكلام من كلمات ملائمة، وتجنب ما يشبهها أو يقاربها صوتًا. |
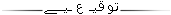  |
| | #37 |
         | معرفة الفصيح من العرب من كتاب المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي أفصحُ الخَلْق على الإطلاق سيدُنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين جلَّ وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أفصح العرب) وأصحاب الغريب رَوَوْه أيضا بلفظ: (أنا أفصَحُ من نَطق بالضاد بَيْدَ أني من قريش)، وتقدم حديث: (أن عمر قال: يا رسول الله مَا لَكَ أفصحنا ولم تَخرج من بين أظْهُرِنا. .) الحديث. وروى البَيْهَقي في شعب الإيمان عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: (أن رجلا قال: يا رسول الله ما أفصحك فما رأينا الذي هو أعرب منك. قال: حق لي فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين) وقال الخطابي: اعلم أن اللهَ لما وضعَ رسوله صلى الله عليه وسلم موضع البلاغ من وَحْيه ونَصَبه مَنْصِب البيان لدينه اختار له من اللغات أعربَها ومن الألْسُن أفصحَها وأبينَها ثم أمدَّه بجوامع الكَلم. قال: ومِنْ فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقْتَضَبَها لم تُسْمَع من العرب قبله ولم توجد في مُتقدّم كلامها كقوله: (مات حَتْف أَنْفه) (وحَمِيَ الوطيس) (ولا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحرٍ مرَّتين) في ألفاظ عديدة تَجْري مَجْرى الأمثال. وقد يدخل في هذا إحْدَاثُه الأسماء الشرعية. انتهى. وأفصح العرب قريش قال ابنُ فارس في فقه اللغة: باب القول في أفصح العرب. أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد مولى بني هاشم بقَزْوين قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عباس الحشكي حدثنا إسماعيل بن أبي عبيد الله قال: أَجْمَع علماؤنا بكلام العرب والرُّواة لأشعارهم والعلماءُ بلُغاتهم وأيامهم ومحالِّهم أن قُرَيْشاً أفصحُ العربِ أَلْسِنَةً وأَصْفَاهُمْ لَغةً وذلك أن الله تعالى اختارَهم من جميع العرب واختارَ منهم محمدا صلى الله عليه وسلم فجعلَ قريشا قُطَّانَ حَرَمه ووُلاَةَ بَيْته فكانت وفودُ العرب من حجَّاجها وغيرهم يَفِدُونَ إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش وكانت قريشٌ مع فصاحتها وحسْن لُغاتها ورِقَّة أَلْسِنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخَيَّرُوا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لُغَاتهم وأصْفَى كلامهم فاجتمعَ ما تخَيَّرواْ من تلك اللغات إلى سلائقِهم التي طُبعوا عليها فصاروا بذلك أفصحَ العرب. ألا ترى أنك لا تجدُ في كلامهم عَنْعَنة تميم ولا عَجْرفية قَيْس ولا كشْكَشَة أسد ولا كَسْكَسَة ربيعة ولا كَسْر أسد وقيس. وروى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات منها خمسٌ بلغة العَجُز من هوازن وهم الذين يقال لهم عُلْيا هوازن وهم خمس قبائل أو أربع منها سعد بن بكر وجُشَم بن بكر ونَصْر بن معاوية وثقيف. قال أبو عبيد: وأحسب أفصحَ هؤلاء بني سعد بن بكر وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أفصح العرب بَيْدَ أني من قريش وأني نشأْتُ في بني سعد بن بكر) وكان مُسْتَرْضعاً فيهم وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: أفصحُ العرب عُلْيا هَوازن وسُفْلَى تميم. وعن ابن مسعود: إنه كان يُسْتَحَبُّ أن يكون الذين يكتبون المصاحفَ من مُضَر. وقال عمر: لا يملين في مصاحفنا إلا غِلْمان قريش وثقيف. وقال عثمان: اجعلوا المُمْلِي من هُذَيل والكاتبَ من ثقيف. قال أبو عبيدة: فهذا ما جاء في لغات مضر. وقد جاءت لغاتٌ لأهلِ اليمن في القرآن معروفةٌ ويروى مرفوعًا: نزل القرآن على لغة الكَعْبَيْن كعب بن لُؤَيّ وكعب بن عمرو وهو أبو خزاعة. وقال ثعلب في أماليه: ارتفعت قريشٌ في الفصاحة عن عَنْعَنَةِ تميم وتَلْتَلةِ بَهْرَاء وكَسْكَسَة ربيعة وكشكشة هوازن وتضجع قريش وعجرفية ضبة وفسر تَلْتَلَة بَهْرَاء بكسر أوائل الأفعال المُضَارعة. وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى (بالألفاظ والحروف) : كانت قريشٌ أجودَ العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النُّطْق وأحسنها مسموعًا وأبينها إبانَة عما في النفس والذين عنهم نُقِلت اللغة العربية وبهم اقْتُدِي وعنهم أُخِذَ اللسانُ العربيٌّ من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثرُ ما أُخِذ ومعظمه وعليهم اتُّكل في الغريب وفي الإعراب والتَّصْريف ثم هذيل وبعض كِنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضَريٍّ قط ولا عن سكَّان البَرَاري ممن كان يسكنُ أطرافَ بلادِهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم فإنه لم يؤخذ لا مِنْ لَخْم ولا من جذَام لِمُجاوَرتهم أهل مصر والقِبْط ولا من قُضاعة وغَسَّان وإياد لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية ولا من تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين مُخالطين للهِند والفُرس ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغةَ العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت أَلسِنتهم والذي نقل اللغةَ واللسانَ العربيَّ عن هؤلاء وأَثْبَتها في كتاب فصيَّرها عِلْماً وصناعة هم أهلُ البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب. انتهى. فرع - رَُتَبُ الفصيح متفاوتةٌ ففيها فصيحٌ وأفصح ونظيرُ ذلك في علوم الحديث تفاوت رُتَبِ الصحيح ففيها صحيحٌ وأَصَحّ. ومن أمثلة ذلك: قال في الجمهرة: البُرُّ أفصحُ من قولهم القَمْح والحنْطة. وأنصَبَه المرضُ أعْلى من نَصَبَه. وغلب غَلَباً أفصح من غلبا. والمغوت أفصحُ من اللَّغْب. وفي الغريب المصنف: قَرَرت بالمكان أجود من قَرِرت. وفي ديوان الأدب: الحبر: العالم وهو بالكسر أصح؛ لأنه يجمع على أفْعال والفَعل يجمع على فُعُول. ويقال: هذا مَلْك يميني وهو أفصحُ من الكسر. وفي أمالي القالي: الأَنملة والأُنملة لغتان: طرف الأصبع وأَنملة أفصح. وفي الصحاح: ضَرْبة لازب أفصحُ من لازم وبُهِت أفصحُ من بَهُتَ وبَهِت. وقال ابنُ خالويه في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وَرَدت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن لا خلافَ في ذلك. فائدة - قال ابنُ خالويه في شرح الدريدية: فإن سأل سائل فقال: أوفى بعهده. أفصحُ اللغات وأكثرها فلِمَ زعمت ذلك وإنما النَّحْوي الذي ينقِّر عن كلام العربِ ويحتج عنها ويَبِين عما أَوْدَع الله تعالى من هذه اللغة الشريفة هذا القبيل من الناس وهم قريش فقل: لمَّا كان وفَى بعهده يجذبه أصلان: مِنْ وفَى الشيء إذا كَثُرَ ووفَى بعَهْدِهِ اختاروا أَوْفَى إذا كان لا يشكل ولا يكونُ إلا للعَهْدِ. |
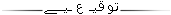  |
| | #38 |
         | أسلوب القرآن وبيان ذلك في اللغة العربية من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزُّرْقاني -رحمه الله- بيان ذلك في لغتنا المحبوبة العربية أن مفرداتها منها متآلف في حروفه ومتنافر وواضح مستأنس وخفي غريب ورقيق خفيف على الأسماع وثقيل كرية تمجه الأسماع وموافق لقياس اللغة ومخالف له ثم من هذه المفردات عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومعرف ومنكر وظاهر ومضمر وحقيقة ومجاز، وكذلك التراكيب العربية منها ما هو حقيقة ومجاز ومنها متآلف الكلمات ومتنافرها وواضح المعاني ومعقدها وموافق للقياس اللغوي والخارج عليه، ومنها الاسمية والفعلية والخبرية والإنشائية، وفيها النفي والإثبات والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير والفصل والوصل إلى غير ذلك مما هو مفصل في علوم اللغة وكتبها. ثم إن ما يؤيده معهود اللغة من المتنوعات المذكورة وما أشبهها هو المسلك العام الذي ينفذ منه المتكلمون إلى أغراضهم ومقاصدهم ولكن ليس شيء من هذه المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقًا ولا شيء منها بالذي يسوء استعماله إطلاقًا أي في كافة الأحوال وجميع المقامات بل لكل مقام مقال فما يجعل في موطن قد يقبح في موطن آخر وما يجب في مقام قد يمتنع في مقام آخر ولولا هذا لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من البلاغة هينًا ولأصبح كلام الناس لونًا واحدًا وطعمًا واحدًا ولكن الأمر يرجع إلى حسن الاختيار من هذه المتنوعات بحسب ما يناسب الأحوال والمقامات، فخطاب الأذكياء غير خطاب الأغبياء وموضوع العقائد التي يتحمس لها الناس غير موضوع القصص، وميدان الجدل الصاخب غير مجلس التعليم الهادئ، ولغة الوعد والتبشير غير لغة الوعيد والإنذار إلى غير ذلك مما يجعل اختيار المناسبات عسيرًا ضرورة أن الإحاطة بجميع أحوال المخاطبين قد تكون متعسرة أو متعذرة ومما يجعل اللفظ الواحد في موضع من المواضع كأنه نجمة وضاءة لامعة وفي موضع آخر كأنه نكتة سوداء مظلمة. ولعلمائنا أكرمهم الله أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين استعمال حرف أو كلمة مكان حرف أو كلمة، ومن السابقين في حلبة هذا الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة 412هـ في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل، وهاك مثالاً منه يفيدنا فيما نحن فيه؛ إذ يتحدث عن سر التعبير بالفاء في لفظ {كُلُوا} من قوله سبحانه في سورة البقرة: {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ} وعن سر التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ {كُلُوا} أيضا لكن من قوله سبحانه في سورة الأعراف: {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ} مع أن القصة واحدة ومدخول الحرف واحد قال رحمه الله الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الجواب بالابتداء وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء ومنه {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا} فإن وجود الأكل متعلق بالدخول والدخول موصل إلى الأكل فالأكل وجوده معلق بوجوده بخلاف {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا} لأن السكنى مقام مع طول لبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من يدخل بستانا قد يأكل منه مجتازا فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء |
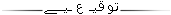  |
| | #39 |
         | البلاغيون والإعجاز البياني خطوات على الطريق من كتاب الإعجاز البياني للقرآن لعائشة بنت الشاطئ هذا الإجماع على إعجاز البيان القرآني، هو الذي نقل القضية إلى الميدان البلاغي على وجه التخصيص، إلى جانب ما يعرض له المفسرون، وبخاصة البلاغيون منهم، من ملاحظ بلاغية في سياق تفسيرهم لآيات الكتاب المحكم. وقد ظهرت محاولات مبكرة في الإعجاز البلاغي، واشتهر عبد القاهر الجرجاني بأنه صاحب مذهب الإعجاز في النظم، واشتهر أبو بكر الباقلانى بأنه أول من بسط القول في بلاغة القرآن. والواقع أن كل المصنفات الأولى التي تحمل عنوان (نظم القرآن) تشير إلى أن مصنفيها اتجهوا إلى الدرس البلاغي "احتجاجاً لنظم القرآن" كما قال الجاحظ في تقديمه كتاب (نظم القرآن) إلى الفتح بن خاقان، ومثله كتاب أبي بكر السجستاني في (نظم القرآن) والكتابان من تراث القرن الثالث. وإذا كنا لا نملك الحكم على مناهج المصنفين الأوائل في الإعجاز البلاغي، ممن لم تصل إلينا كتبهم، فلننظر في مناهج الذين بقيت كتبهم معالم لخطواتهم على الطريق. سبق "الخطابي" من القرن الرابع الهجري - ت 388 هـ - في رسالته (بيان إعجاز القرآن) إلى شرح فكرة الإعجاز بالنظم، إيضاحاً للإعجاز من جهة البلاغة "الذي قال به الأكثرون من علماء أهل النظر" قبله، وإن كانت فكرتهم فيه قائمة على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن. أو كما قال: "وفي كيفيتها - جهة البلاغة - يعرض لهم إشكال ويصعب عليهم منه الانفصال. ووجدتُ عامة أهل هذه المقالة - الإعجاز من جهة البلاغة - قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به، ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي أختص بها القرآن، الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا: إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون عند سماعه ضرباً من المعرفة لا يمكن تحديده. وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذي يقع فيه التفاضل، فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفةُ ذلك، ويتميز في أفهامهم قبيلُ الفاضل من المفضول منه. قالوا: وقد يخفى سببه عند البحث ويظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. قالوا: وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا يوجد مثلها لغيره منه، والكلامان معاً فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة. "قلت: وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم، ولا يشَفى من داء الجهل به، وإنما هو إشكال أُحِيلَ على إبهام. . . "فأما من لم يرضَ من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن ظاهر العلة. . . فإنه يقول إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السامع الهشاشة في نفسه، وما يتحلى به من الرونق والبهجة التي يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب وتَحصى الأقوال عن معارضته وتنقطع به الأطماع عنها، أمر لابد له من سبب، بوجوده يجب له هذا الحكمُ وبحصوله يستحق هذا الوصف" 24: 26 ومناط البلاغة في النظم القرآني، عند الخطابي، إنه "اللفظ في مكانه إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة" 29 وهذا الملحظ الدقيق، هو المحور الذي أدار عليه عبد الظاهر مذهبه في الإعجاز بالنظم، وهو أيضاً مما يلتقي - إلى حد ما - مع جوهر فكرتنا في الإعجاز البياني، ثم نختلف بعد ذلك في تحقيق مغزاه ولمح أبعاده وطريق الاحتجاج له: فالخطابي حين يقول بسقوط البلاغة لفساد المعنى أو ضياع الرونق، يتجه إلى الرونق اللفظي فيجعله غير فساد المعنى. وسنرى الجرجاني يعتمد هذه التفرقة بين المعنى واللفظ أساساً لنظريته في النظم، على حين لا نرى اللفظ منفصلاً عن معناه بحيث يمكن أن يصح أحدهما والآخر فاسد، بل يفسد المعنى بفساد لفظه، ولا عبرة عندنا برونق لفظي مع فساد المعنى. ثم إن الخطابي في شرح فكرته في النظم المعجز، يرى من الإعجاز أن تأتي بلاغات القرآن جامعة لطبقات ثلاث متفاوتة من حيث المستوى بعد استبعاد الهجين المذموم. قال: "والعلة فيه - يعني إعجاز القرآن من جهة البلاغة - أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية: فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، دون النوع الهجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة: "فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه. والقسم الثاني أوسطه وأقصده، والقسم الثالث أدناه وأقربه، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة" 26 والعبارة موهمة، قد يُفهم منها أن في القرآن ما هو من الدرجة العليا في البلاغة وفيه ما هو من أوسطها وأدناها. وذلك مردود عندنا من ناحيتين: أولاهما: أن فهمنا للإعجاز البياني، فوت لأعلى درجات البلاغة دون أوسطها وأدناها. والأخرى، أن هذه الدرجات الثلاث لا تجتمع، بالضرورة، في السورة الواحدة، وبسورة واحدة كان التحدي والمعاجزة. وسبق "الخطابي" أيضاً إلى لمح فروق دقيقة في الدلالة، لألفاظ قرآنية جرت معاجمنا وكتب المفسرين على القول بترادفها مع "ألفاظ أخرى في معناها" مثل: العلم والمعرف، الحمد والشكر، العتق وفك الرقبة، (29: 33) . . . وهذا أيضاً مما نتزود به لطريقنا إلى فهم الإعجاز البياني، على ما سوف نوضحه في: "الترادف وسر الكلمة". وتجرد الخطابي لدفع شبهات من جادلوا في بلاغة عبارات قرآنية قالوا إنها جاءت على غير المسموع من فصيح كلام العرب. وفي ردَّ الخطابي عليهم ملاحظُ دقيقة، غير أنا نختلف معه، من حيث المبدأ، في قبول عرض العبارات القرآنية على ما نقل عصر التدوين من فصيح كلام العرب. والأصل أن يعرض هذا الذي نقلوه على القرآن، إذ هو الفصحى والنص الموثق الذي لم يصل إلينا من أصيل العربية بنص آخر صح له مثل ما صح للقرآن من توثيق يحميه من شوائب الرواية النقلية، وما لألفاظه من حرمة لا تجيز رواية بالمعنى، فضلاً عما في الشواهد الشعرية من ضرورات لا مجال لمثلها في الشواهد القرآنية. وتفرغ الخطابي في النصف الأخير من رسالته، لنقض ما سموه "معارضات للقرآن" من مدّعي النبوة، فبسط القول في معنى المعارضة وشروطها ورسومها، وضرب الأمثلة من معارضات امرئ القيس وعلقمة في وصف الفرس، وامرئ القيس والحارث بن التوءم اليشكرى في إجازة أبيات، كما ضرب أمثلة من تنازع الشاعرين معنى واحداً، كأبيات في وصف الليل لامرئ القيس والنابغة الذبيانى، وفي وصف الخمر للأعشى والأخطل، وفي صفة الخيل لأبي دؤاد الإيادي والنابغة الجعدي. وقابل هذا كله إسفاف مسيلمة الكذاب وسُخف من تكلم في الفيل مبيناً سقم كلامهم وعدم استيفائه شروط المعارضة ورسومها. . . ولهذا الفصل من رسالة الخطابي قيمته في المباحث البلاغية والنقدية المبكرة. ونرى مع ذلك أن أبا سليمان كان في غنى عن الاشتغال بهذيان من ادّعوا النبوة بعد عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجاءوا بسخافات هابطة سقيمة يعارضون بها القرآن فيما زعموا. وهي عندنا أهون من أن توضع في الميزان أو يشار إليها في مجال الاحتجاج لإعجاز القرآن من جهة البلاغة. ومجرد ذكرها في هذا المقام الجليل، ولو للكشف عن سقمها وإسفافها، يرفع شأنها ويعطيها من القيمة ما لا تستحق. . . * * * |
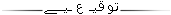  |
| | #40 |
         | بيان تلازم علوم القرآن وعلوم العربيّة من عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم للدكتور سليمان العايد لم يمرّ بالعربيّة حدثُّ أعظم من الإسلام، ونزول القرآن على محمّد صلى الله عليه وسلم، فقد صيَّر هذا الحدث العربيَّةَ لغة مرغوباً فيها، لا لنفوذها السياسيِّ، ولا لسبقها الحضاريّ، وإنّما لمكانتها الدينيّة؛ إذ تسامى أهل البلاد المفتوحة إلى درس العربيّة، والعناية بها، من أجل تحقيق العبادة، ومن أجل تلاوة القرآن، ومن أجل فهم النصوص الشرعية، فكان من جرَّاء ذلك نشأة علوم العربية من نحو وصرف، ولغة ومعجم، وأدب وبلاغة، كُلّ ذلك وُجِدَ ليقومَ عليه درسٌ للعربيّة قويّ. وصار هذا الأمر في حسِّ المسلم عقيدةً وواجباً شرعيّاً، لا يختلف في ذلك من لغته العربيّة، ومن لغته غير العربيّة، وصارتْ لغة القرآن وما داناها من لغةٍ لغةً وهدفاً يتسامى إليه أهل الإسلام، وتَشْرَئِبُّ إليه أعناقهم، وتتطاول إليه هاماتهم، وعدوا القرآن نموذجاً أعلى للبيان العربيّ، فأقبلوا عليه يبحثون عن وجوه بيانه، وأسرار إعجازه، ممّا كان سبباً في نشأة علوم العربيّة. إنّه لولا القرآن، ولولا الإسلام لم يكن هناك عربيّةٌ كما نرى، أو لبقيَتْ العربيَّةُ لغة فئةٍ معزولةٍ عن العالم، تعيش في صحرائها، يزهد فيها العالم، ويرغب عنها إلى غيرها، غير أنَّ الإسلام نقل العربيّة إلى بُؤْرة الاهتمام العالميّ، وجعل لها الصدارة، اهتماماً، وتعلّماً، يطلبها العربيُّ وغَيْره، ويغار عليها كل مسلم، ويتمنّى أن يتقنها كُلّ مُصَلٍّ، ذلك أنّها تحلّ في قلبِ كلّ مسلم في أعلى مكانٍ منه، وهي أجلّ وأكبر لديه من كل لسانٍ، وكل لغة. دخل الناس في الإسلام، وانقادوا له راغبين أو خاضعين، فتعلّموا لسانه، ورأوا أنه لا يتمُّ لهم دينٌ إلاّ بلغته، فبادروا إلى خدمتها، والعنايةَ بها، كما بادروا إلى حفظ القرآن والسُّنَّة، ودرس التفسير والحديث، ومعرفة أصول الدين والفقه، بل جعلوا اللسان العربيّ بوّابة إلى هذه العلوم، لا يولج إليها إلاّ به، بل نسي كثيرٌ أن له لغةً غير العربيّة، وانصرف فكره إليها، حتّى إنّ بعضهم ما كان يطيب له أن يذكر لغته الأولى وقد أكرمه الله باللسان العربي، فضلاً عن أن يقارن تلك اللغة بلسانه الجديد. وفرغت فئاتٌ من المسلمين من غير العرب، من الموالي لخدمة اللسان العربيّ في مستوياته المختلفة: الصوتيّ، والصرفي، والتركيبي، والدلاليّ، لم يقتصر أمره على ما ورد به استعمال القرآن أو السُّنَّة، بل جاوزه إلى جمع اللغة، وإحصاء شاردها ونادرها، وحصر غريبها وشاذّها، في جهدٍ لم يتحقّق للغةِ من اللُّغاتِ، وعملٍ لم يحظ به لسانٌ من الأَلْسِنةِ، حتّى رأينا من مصنّفات العربية الشيء العجاب، ألّفه أو اكتتبه قومٌ ليسوا من أهلها نسباً، ولكنهم منهم ولاءً وحُبّاً. أقبلت الأمّة على كتاب ربّها، وأكبّت عليه حفظاً، ودرساً، وفهماً لمعانيه، وتقيُّداً بأحكامه، وميزاً لألفاظه ومبانيه، ومعرفة لطرائق رسمه، وإسناد قراءاته، وكان لعلماء العربيّة اليدُ الطولى في خدمة القرآن، في ميادين متنوّعة، في رسمه وضبطه، ومعانيه وقراءاته، وأبنيته وألفاظه، وبلاغته وإعجازه، بل لا أبالِغُ إذا قلتُ: إنّ علوم العربية لولا القرآن ما كانت، ولا كان للعربية شأن، ولبقيت محصورةً في صحرائها القاحلة، وجزيرتها العازبة عن حياة الحضارة والمدنيّة، ولبقي أهلها على شائهم ونَعَمِهم، يتتبعون من أجلها مواقع القطر، ومنازِلَ الغيث، ويعنون بما يرتبط بهذه الحياة البسيطة، من علمٍ بالأنواء والمنازل، والأفلاك والأبراج، والريح وأوقات هبوبها، لا يجوزون هذا إلاّ إلى معرفة أنسابهم، والفخر بأحسابهم، والتمدّح بفعالهم، وإلا قول الشعر، وارتجال الخطب، وحفظ ما استجادوا من ذلك، وإلاّ نُتفاً من حِكَمٍ وأمثالٍ، تهديهم إليها تجاربهم في الحياة، لا هَمَّ لهم وراء ذلك، ليلٌ ينجلي، ونهارٌ يتجلَّى: "ليلٌ يكرُّ عليهم ونهارُ" في دورةٍ فلكيّة مكرورةٍ، فسبحان من غيَّر هذه الأُمَّة لتكون كما قال ابن فارسٍ: " كانت العربُ في جاهليتها على إرثٍ من إرثِ آبائهم في لغاتهم، وآدابهم، ونسائكهم، وقرابينهم، فلمّا جاء الله (جلَّ ثناؤه) بالإسلام حالتْ أحوالٌ، ونُسِخَتْ دياناتٌ، وأُبْطِلت أمورٌ، ونُقِلَتْ من اللُّغة ألفاظٌ عن مواضع إلى مواضع أخر، بِزياداتٍ زيدتْ، وشرائع شُرِعَتْ، وشرائط شُرِطت، فعفَّى الآخِرُ الأوّلَ، وشُغِل القوم - بعد المغاورات والتجاراتِ، وتطلّب الأرباح، والكدح للمعاشِ في رحلة الشتاء والصّيف، وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة - بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميد، وبالتفقُّه في دينِ الله عز وجلّ وحفظ سُنَنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام. فصار الذي نشأ عليه آباؤهم، ونشؤوا هم عليه كأن لم يكن، وحتّى تكلّموا في دقائقِ الفقه، وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة، وتأويل الوحي بما دُوّن وحفظ. فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عمّا ألفوه، ونشؤوا عليه، وغُذوا به، إلى مثل هذا الذي ذكرناه" . هذا فِعْل الإسلام بأمَّةِ العرب، أمّا غيرهم فهم كما قال أبو حاتم: "أقبلتِ الأمم كُلّها إلى العربيّة يتعلّمونها رغبةً فيها، وحرصاً عليها، ومحبَّة لها وفضلاً أبانه الله فيها للناس، ليبيِّن لهم فضلَ محمّد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وتثبُت نبوَّته عندهم، وتتأكّد الحُجَّة عليهم، وليظهر دين الإسلام على كُلِّ دينٍ؛ تصديقاً لقولِه (عزَّ وجلَّ) حيثُ يقولُ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33] . ولو ذهبنا نَصِفُ اللُّغاتِ كُلَّها عجزنا عن تناول ما لم يُعْطَه أَحَدٌ قبلنا، ولكنّا نذكر من ذلك على قدر المعرفة، ومقدار الطاقةِ، ونتكلَّم بما علمنا منه محبَّةً لإيرادِ فَضْلِ لغة العرب؛ إذْ كان فيه إظهار فضيلة الإسلام على سائر الملل، وإبراز فضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياءِ والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كان ذلك ظاهراً بنعمة الله، بارزاً بحمد الله؛ لأن دين الإسلام عربيّ، والقرآن عربيّ، وبيان الشرائع، والأحكام، والفرائض، والسنن بالعربية" . لولا الإسلام، والقرآن لم تحظَ اللُّغةُ العربيَّةُ بما حظيَتْ به من خدمةٍ، بتدوين علومها، وتبويب مسائلها، وتتابع أجيالٍ فأجيالٍ على النظر فيها جمعاً، وتأليفاً، وتقعيداً، وبحثاً عن أوجه جمالها، وإعجاز قرآنها، وتمجيداً لها وتعظيماً، ليس من أبنائها ذوي الأعراق العربيّة، وإنما من أبنائها ذوي الأصول الأعجمية، ممّن كانت لغتهم الأُمّ أو الأولى غير العربيّة؛ إذ من المعروف أن عدداً غير قليل من أبناء الشعوبِ الإسلامية انتحلوا العربيّة، فصارت لغتهم ولسانهم، وتناسوا بل هجروا لغتهم الأُمَّ، وكتبوا في تمجيد العربية، وبيان فضلها، والتعصُّب لها ما لم يكتبه قلمٌ من صليبةٍ عربيَّةٍ، ولنا أن نمثِّل في هذا السياقِ بجمهرةٍ من علماء العربية وغيرهم من مثل أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255هـ) وأبي حاتم الرازي (ت 322 هـ) وأبي علي الفارسي (ت 377هـ) وأحمد بن فارسٍ (ت 395) وأبي حيَّان التوحيدي (ت 414هـ) . وكانوا جميعاً من أعراقٍ غير عربيّة، ولم تمنعهم تلك الأعراق عن الإشادة بالعربيّة تمجيداً لها وتعظيماً، وتفضيلاً وتقديماً، ليس لهم دافع إلاّ أنهم مسلمون، قرؤوا القرآن، ورأوا ما فيه من أوجه البيان، وسر النظم، ودلائل الإعجاز، ورأوا أن لُغةً اختيرتْ لهذا الكتاب لم يكن اختيارها عبثاً؛ لأنّ الاختيار من رَبِّ العالمين، ذي الخلق والأمر، اختص بالرحمة وقسمتها، كل شيءٍ عنده بحكمةٍ ومقدار، يخلُقُ ما يشاءُ ويختار ما يشاء، له الحكمة البالغة في ذلك. وقد حمل نزول القرآن باللغة العربية طائفةً أن يجعلوه دليل فضلها على سائر اللغات، نجد ذلك في مثل قول أبي حاتمٍ الرَّازيّ (ت 322هـ) : "فأفضل ألسنة الأمم كلها أربعة: العربية، والعبرانية، والسريانية، والفارسية؛ لأن الله (عزّ وجلّ) أنزل كتبه على أنبياء (عليهم السلام) آدم، ونوح، وإبراهيم، ومن بعدهم من أنبياء بني إسرائيل بالسريانية والعبرانية، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، وذكر أن المجوس كان لهم نبيٌّ وكتابٌ، وأنّ كتابه بالفارسيّة، هذا ما اتّفق عليه أصحاب الشرائع" . وقد جعل الرّازي العربيّة أفضل اللغات الأربع، وأفصحها، وأكملها، وأتمّها، وأعذبها، وأبينها، وجعل حرص النّاس على تعلّم العربية علامة فضلها، ونقل الكتب السماوية المنزلة بغير العربية إلى العربية، ونقل حكمة العجم إليها، وما في كتب الفلسفة، والطب، والنجوم، والهندسة، والحساب من اليونانية والهندية إلى العربيّة وجهاً آخر لفضلها، في حين لم يرغب أهل القرآنِ والكتاب العربيّ في نقله إلى شيءٍ من اللُّغات، ولا قدر أحدٌ من الأمم أن يترجمه بشيء من الألسنة ... بل تعذَّر عليهم لكمال العربيّة، ونقصان غيرها من سائر اللغات . وقد قال نحواً من هذا ابن فارس، بل لعلّه اقتفاه في أن الترجمة الحرفية للقرآن متعذّرة، وأنه لا يمكن إلا أن يحال القرآن إلى عبارةٍ سهلة، تخلو من سمات لغة الأدب، ثم يترجم معناها فيما بعد، ومثل لهذا بمثل قوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58] )) . ولابن فارس كلامٌ نحو هذا، ينحو إلى تفضيل العربية على غيرها لنزول القرآن بها، في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها) ، وهو كتابٌ ينضح بالتمجيد والتعظيم، وبيان فضل العربيّة على غيرها من اللُّغات، ممّا يعدُّه بعضٌ تعصُّباً غير مقبول، وهو من وجهة نظرنا عمل عظيم، خاصَّةً إذا علمنا حقيقة البيئة المحيطة بابن فارسٍ، وهي بيئةٌ تدعو لإحياءِ المجد الفارسيّ، وإحياء اللّغة الفارسيّة، حتّى إنّ الفارسية الحديثة كان تأسيسها في عصر ابن فارسٍ، وقد سار على نقيض قومه. وابتدأ هذا التمجيد بتقرير أنّ العربيّة توقيفٌ من عند ربِّ العالمين، ولم يسم لغةً أخرى بهذه السِّمة، وكأنّه يرى أنّ هذه ميزةٌ انفردت بها العربيّة عن لغات العالم، فكانت العربيّة وحياً حُفِظ حتّى نزل بها القرآن، فانضمَّ الوحي إلى الوحي، وهذا كأنّه يقول فيه كما أنّ للعرب وأتباعهم ديناً امتاز عن غيره بأنه وحيٌّ مصون، لم تمسَّه يد التغيير، فإنّ للعرب أيضاً لغةً مصونةً مرعيَّةً برعاية الله، صانتها عن التغيير والابتذال، ورقت في مراقي المجد والسُّموّ، يحفظها ربُّها ويهيّؤها، وهي أعلى لغةٍ، لنزول أعلى كتابٍ بها، وأعظم دين، وخاتم الأديان، الإسلام، هذا كلام لا يعسُرُ عليك استنباطه من كلامه. وابن فارسٍ يتوسع في التوقيف، فيرى أن العربيّة توقيف في ألفاظها، وأصواتها، وأبنيتها، وتراكيبها، وأساليب بيانها، بل كتابتها وخطها، وعلومها من إعرابٍ، وعروض ، حتى إنّه عدّ ما ذكره من أصول وقياسٍ توقيفاً كما عقد باباً لبيان أنّ ((لغة العرب أفضل اللُّغات وأوسعها)) ، صدّره بقوله تعالى {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 192-195] فوصفه (جلّ ثناؤه) بأبلغ ما يوصَفُ به الكلام، وهو البيان . وهو بيانُّ متميِّزٌ لا يقتصر على مجرَّدِ الإبانةِ، وإنّما يتجاوزُ ذلك إلى قيمٍ كلامية وتعبيريّة، قلّ أن تتوافر في غيرِ العربيّة، ممّا يُعْجِزُ النَّقَلة عن نقل القرآنِ إلى لغاتهم بدرجة بيانه العربي. وهذه سمةٌ ليسَتْ مقصورةً على القرآنِ، بل هي في الكلام العربيِّ كُلِّه، جاهليِّه وإسلاميِّه، لكنّها تجلَّت أكثر في كلام ربِّ العالمين، القرآن المجيد، حتى قال ابن فارسٍ: "إنّ كلام الله (جَلَّ ثناؤه) أعلى وأرفع من أن يضاهى، أو يقابل، أو يعارضَ به كلامٌ، وكيف لا يكون كذلك، وهو كلام العليِّ الأعلى، خالق كُلِّ لغةٍ ولسان، لكنّ الشعراء قد يومئون إيماءً، ويأتون بالكلام الّذي لو أراد مُريدٌ نَقْلَه لاعتاص، وما أمكن إلاّ بمبسوطٍ من القولِ، وكثيرٍ من اللّفظ" . ثمّ ذكر نماذج من الشعر وكلام العرب . ثمّ ذكر شيئاً ممّا جعله خصائص للعربية من القلب، وعدم الجمع بين الساكنين، والحذف، واختلاس الحركات، والإضمار، والترادف، ثمّ ختمه بقوله: (فأين لسائر الأمم ما للعرب؟!) . ولم يقف به الأمر عند تمجيد العربيّة وتفضيلها، بل جاوز إلى بيان ما اختصّت به العربُ كالإعراب الفارق بين المعاني المتكافئةِ في اللّفظ، وعنايتهم بالشعر والعروض. مع حفظ الأنساب، والطهارة، والنزاهة عن الأدناس التي استباحها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم . وقد بلغت العربية - كما يرى ابن فارسٍ - غاية كمالها بعد مجيء الإسلام، وتنزُّل القرآن، فجدّت في العربيّة ألفاظ ومعانٍ، وزالت ألفاظ لزوال معانيها، ونقلت ألفاظٌ عن معانيها إلى معانٍ أخرى، كراهةً لأصل معناها، أو تأدُّباً، أو اقتفاءً لأمر الشرع، وقد هذَّب الإسلام ألفاظ العربيّة، ووجَّه العربَ لاختيار أسماء أولادهم . وقد ارتبطت العربية بالقرآن بأوثق رباط، حتى إنه ليعسر على الدارس الفصل بينهما، قال الرافعي: "إنّ هذه العربية، لغة دينٍ قائم على أصلٍ خالدٍ، هو القرآنُ الكريم، وقد أجمع الأوّلون والآخرون على إعجازه بفصاحته، إلاّ من حَفلَ به من زنديقٍ يتجاهل، أو جاهلٍ يتزندَقُ" . والقرآن هو الذي أخرج فصحاء الأدب العربيّ وبلغاءه من أمثال ابن المقفّع، ولولا القرآن والحديث، وكتب السلف وآدابهم لم يخرج أمثاله . ويحاول غير المسلمين بوعي، ومرضى القلوب بغير وعيٍ أن يعزلوا المسلمين عن قرآنهم ولُغته، حتّى عاب بعضهم على الرافعي أسلوبه، واقترح عليه ترك الجملة القرآنية، ويعنون بها اللغة العالية، والأسلوب الراقي، الذي يسمو بصاحبه إلى لغة القرآن، وأسلوبه، ومنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفصحاء العرب، وأدباء العربيّة، فهذا القرآن كما هو نور لعقولنا، وحياة لقلوبنا هو حلاوة على ألسنتنا، شارة كمالٍ في منطقنا وبياننا: يديرونني عن سالمٍ وأُديرُهُمْ ... وجلدة بين العين والأنف سالمُ يخاتلوننا ليصرفونا عن لغة القرآن وبيانه، كما خاتلونا ليصرفونا عن العمل به وتلاوته، حتى صار التجديد في اللغة والبيان عند كثيرٍ هو التخلِّي عن لُغةِ القرآن وبيانه، والانسياق وراء الرطانة الأعجمية، واللُّكنة المعوجّة، والدعوة إلى أن نسوّد الصفحات بأحرفٍ عربيّة، ولغةٍ غير عربيّة، وإن تحلّت بزيِّها ورسِمَتْ برسمها . فالقرآن هو سرُّ هذه اللغة، وحياتها، قال الرافعيُّ: "إنّ هذه العربيَّة بُنيَتْ على أصلٍ سحريّ يجعل شبابها خالداً عليها، فلا تهرم ولا تموتُ؛ لأنّها أُعِدَّتْ من الأَزَلِ فلكاً دائِراً للنيِّرين الأرضيين العظيمين: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثَمَّ كانت فيها قُوَّةٌ عجيبةٌ من الاستهواء، كأنّها أخذةُ السِّحر، لا يملك معها البليغ أن يأخذ أو يدع" . وكُلُّ حربٍ يديرها أعداؤنا وعملاؤهم للفصاحة والبلاغة، والبيان العالي لا يُقْصَدُ بها حرب اللسان والبيان، وإنما هي حربٌ لأصلهما من قرآنٍ وحديثٍ، وكلام سلف . وكان العلم باللغة شرطاً للإمامة في علوم الدّين، وصفةً على غايةٍ من الأهمّية للأئمّةِ المجتهدين، وكان الشافعي خير مثالٍ لذلك، فقد كان له محلٌّ يتبع |
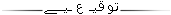  |
| | #41 |
         | من اللغة، شهد به أهلها ، حتى عدّوا قوله حُجّة فيها، وجعلوه كبطنٍ من بطون العرب . قال ثعلب: يأخذون على الشافعي، وهو من بيت اللغة، يجب أن يؤخذ عنه . وقد قرأ عليه الأصمعيُّ، واستفاد منه مع كبر سنِّه، وتقدُّمه في العلم والأدب . وأثنى عليه أهل اللغة الأوائل كابن قتيبة (ت 276 هـ) وأبي القاسم الخوافي (ت 450 هـ) وأبي بكر بن دريد (321 هـ) وأبي منصور الأزهريّ (ت 370 هـ) بقوله "وألفيت أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعيّ (أنار الله برهانه، ولقّاه رضوانه) أثقبهم بصيرةً، وأبرعهم بياناً، وأغزرهم علماً، وأفصحهم لساناً، وأجزلهم ألفاظاً، وأوسعهم خاطراً فسمِعْتُ مبسوطَ كتبه، وأمّهاتِ أصوله من بعض مشايخنا، وأقبلْتُ على دراستها دهراً، وأسنفْتُ بما استكثْرتُه من علم اللغة على تفهُّمها؛ إذْ كانت ألفاظه عربيَّةً محضة، ومن عجمة المولَّدين مصونة" . وقد جرتِ الأُمَّة على تفضيل المقدّمين في علم العربية في طلب القراءة،والسنة، وعلوم الشريعة. قال أبو حاتم: "من أراد السُّنَّة والأمر العتيق في الدين وقراءة القرآن، فليكن ميله إلى الحرمين وأهل البصرة، فإنّهم أصحاب اقتصادٍ في القراءة، وعلم بها وبعللها، ومذاهبها، ومجاري كلام العرب ومخارجها، وكان منهم علماء الناس بالعربيّة وكلام العرب، وكان منهم أبو الأسود الدُّؤليّ، وأبو الحارث ابنه، ويحيى بن يعمر العدواني، وعبد الله بن أبي إسحاق من بعد، وأبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيبَ، والخليل بن أحمد، وأبو زيدٍ، وسيبويه، والأخفش، فهؤلاء الأئمةُ في هذا الشأن، ثمّ بنى على ذلك من جاء بعدهم من علماء اللغة، وتفتَّقَتْ لهم الفِطَنُ، وصرف إليه كثير من النّاسِ هممهم، حتّى جعلوا له ديواناً يفزع إليه، ويعتمد عليه، وجعلوه للغة العرب معياراً، فإذا وجدوا اللّحن في كلامهم وزنوه به فقوَّموه، لأنَّ اللحنَ يزيل الحرفَ عن معناه، ويحيد به عن سننه، وليس هذا لسائر الأمم، وهو علمٌ جسيم، له خطرٌ عظيم" . والحاجة إلى علوم العربية في علوم الدين كانت هي الدافع لحفظ لغة العرب، وشعرها، وكلامها، وأمثالها، وأنسابها، وسائر علومها، قال أبو حاتم: "ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب، والاستعانة بالشعر على العلم بغريب القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والتابعين، والأئمّة الماضين، لبطل الشعر، وانقرض ذكر الشعراء، ولعفَّى الدّهرُ على آثارهم، ونسي النَّاسُ أيَّامَهم، ولكنّ الحاجة بالمسلمين ماسَّةٌ إلى تعلُّم اللغة العربيّة، ومعاني الألفاظ الغريبة في القرآن والحديث، والأحكام والسُّنن، إذْ كانَ الإسلام قد ظهر - بحمد الله - في جميع أقطار الأرض، وأكثر أهل الإسلام من الأمم هم عجمٌ، وقد دعتهمُ الضرورةُ إلى تعلُّم لغة العرب، إذْ كانتِ الأحكام والسُّنن مُبَيَّنةً بلسان العرب " . ولم تكن هذه الحاجة ظاهرةً في عهد النبوّة وصدر الإسلام، لاستغنائهم بسلائقهم وما يسمعونه من كلام العرب؛ إذ كان الكلام مدركاً مفهوماً، وسنن العرب في كلامها ظاهرة معلومة: "قال أبو عبيدة: إنّما أنزل القرآن بلسانٍ عربى مبين، وتصديق ذلك في آيةٍ من القرآن {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195] وفي آيةٍ أخرى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] قال: ولم يحتجِ السلف ولا الّذين أدركوا وحْيَه إلى أن يسألوا النّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن معانيه؛ لأنّهم كانوا عرب الألسُنِ، فاستغنوا بعلمهم عن معانيه، وعمّا فيه ممّا في كلام العرب مثله من الوجوه والتخليص، قال الزُّهْريُّ: إنّما أخطأَ النّاسُ في كثيرٍ من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. قال أبو عبيدٍ: سمعْتُ الأصمعيّ يقولُ: سمعْتُ الخليل بن أحمد يقولُ: سمعْتُ أبا أيُّوبَ السِّخْتياني يقول: عامَّةُ من تزندقَ بالعراق لقلَّةِ علمهم بالعربيّة" . وقد قام علماء العربية بواجبهم نحو الدين والقرآن، فجمعوا ما الحاجة داعية إلى جمعه، ودوّنوا ما علوم الشريعة مفتقرة إليه، ونظّموه بطرق تيسّر الوصول إليه، قال أبو حاتم: "ورأينا العلماء باللغة العربيّة قد كفوا النّاسَ مئونة هذا الشأن، وأحكموه إحكاماً بيّناً، لما دوّنوه من أشعار الشعراء، وألَّفوه من المصنّفاتِ، ووصفوه من الصفات في كُلِّ ما قدروا عليه، ممّا يحتاج النّاس إلى استدراكه، حّتى لعلّه لم تفتهم كلمةٌ غريبةٌ، ولا حرفٌ نادر إلاّ وقد ربطوه بأوثقِ رباطٍ، وعقلوه بأحكم عقالٍ، ورسموا في ذلك رسوماً، وعوّلوا في ذلك كلّه على الشعر، والاحتجاج به، وهذا للغة العرب خصوصاً ليس هو لسائر لُغاتِ الأمم، وذلك كُلُّه لشدّة حاجة الناسِ إلى معرفة لغة العرب، ليصلوا به إلى ما ذكرنا من معاني القرآن والألفاظ الغريبة فيه، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، والأئمة الماضين، وما يجيء في الشريعة من الأسامي في أصول الفرائض والسُّنن، ممّا الجهل به نقص ظاهر على المرء المسلم، وشينٌ فاضح على كُلِّ ذي دين ومروءة " . |
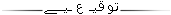  |
| | #42 |
         | الغريب اللغوي والغريب القرآني من كتاب معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم لفوزي يوسف الهابط الغريب اللغوي: كل ما ورد في مادة (غ ر ب) يفيد البُعد، ومنه: رجل غريب: بعيد عن أهله، ليس من سائر القوم. ومنه: كلمة غريبة: أي بعيدة عن الفهم . وذكر الخطَّابِي (ت 388هـ) أن الغريب - من الكلام - يقال به على وجهين: أحدهما: أن يُراد به: بعيد المعنى، غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بُعد، ومعاناة فكر. والآخر: أن يراد به: كلام من بَعُدت به الدار، من شواذِّ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم: استغربناها! وإنما هي كلام القوم وبيانهم. ويزيد الزجّاجي (ت377هـ) أمر الغريب اللغوي وضوحاً، حين يُعرِّفه بأنه : "ما قل استماعه من اللغة، ولم يَدُرْ في أفواه العامّة، كما دار في أفواه الخاصّة، كقولهم: صَمَكْتُ الرجُل، أي: لَكَمْتُه، وقولهم للشمس: يُوحُ" ثم ينبهنا إلى أنه "ليس كل العرب يعرفون اللغة كلها، غريبها وواضحها، ومستعملها وشاذها، بل هم - في ذلك - طبقات، يتفاضلون فيها، كما أنه: ليس كلهم يقول الشعر، ويعرف الأنساب كلها، وإنما هو في بعض دون بعض"! وقريب من هذا: ما ذهب إليه ابن الأثير (ت606هـ) حين قسَّم الألفاظ المفردة إلى قسمين: أحدهما: خاص، والآخر: عام. أما العام: فهو ما يشترك في معرفته، جمهور أهل اللسان العربي، مما يدور بينهم في الخطاب، فهم - في معرفته - سواء، أو قريب من السواء، تناقلوه فيما بينهم، وتداولوه، وتلقفوه من حال الصغر - لضرورة التفاهم - وتعلموه. وأما الخاص: فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية، والكلمات الغريبة الحوشيّة، التي لا يعرفها إلا من عُني بها، وحافظ عليها، واستخرجها من مظانها، وقليل ما هم! وذهب ابن الهائم (ت 815هـ) إلى "أن الغريب يقابله المشهور، وهما أمران نِسبِيَّان، فربَّ لفظ يكون غريباً عند شخص، مشهورا عند آخر" الغريب القرآني: أما الغريب في القرآن الكريم: فهو الألفاظ القرآنية، التي يُبْهَم معناها على القارئ، والمفسر وتحتاج إلى توضيح معانيها، بما جاء في لغة العرب، وكلامهم . وذلك: لأن ألفاظ القرآن - أو لغاته، كما يقول أبو حيان الأندلسي (ت745هـ) - "على قسمين : قسم: يكاد يشترك في معناه، عامة المستعربة، وخاصتهم، كمدلول السماء، والأرض، وفوق، وتحت. وقسم: يختص بمعرفته، من له اطلاع وتبحُّر في اللغة العربية، وهو الذي صَنّف أكثر الناس فيه، وسمَّوه: غريب القرآن". أهمية معرفة غريب القرآن: ومعرفة غريب القرآن - بالنسبة للمفسر - من أهم أدواته، لأنها من أوائل المُعَاوِن، لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللَّبِنِ، في كونه من أول المُعاوِن، في بناء ما يريد أن يبنيَه. وليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع! فألفاظ القرآن: هي لُبُّ كلام العرب، وزُبْدتُه، وكرائمُه، وعليها اعتماد الفقهاء، والحُكام في أحكامهم، وحِكَمِهم، وإليها مفزع حُذّاق الشعر، والبلغاء، في نظمهم وشعرهم، وما عداها - وعدا الألفاظ المتفرعات عنها، والمشتقات منها - هو - بالإضافة إليها - كالقشور والنوى، بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن، بالإضافة إلى لُبوب الحنطة! ومن أجل ذلك: فقد نبه الزركشي (ت794هـ) إلى ضرورة معرفة الغريب، والإحاطة باللغة، بالنسبة للمفسر، وساق - في هذا المجال - قول الإمام مالك بن أنس (ت179هـ) : "لا أُوتَى برجل يفسّر كتاب الله، غيرَ عالم بلغة العرب، إلا جعلته نكالا" ثم قولَ مجاهد (ت104هـ) : "لا يحل لأحد- يُؤمن بالله واليوم الآخر - أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالماً بلغات العرب". كما ذكر (الزركشي): أن الكاشف عن معاني القرآن، يحتاج "إلى معرفة علم اللغة: اسما، وفعلاً، وحرفاً، فالحروف - لقلتها - تكلم النحاة على معانيها، وأما الأسماء والأفعال: فيؤخذ ذلك من كتب اللغة". تفاوت نظرة المفسرين إلى الغريب: ولم ينظر علماء اللغة، والمهتمون بأمر غريب القرآن، إلى ذلك الغريب، نظرة واحدة، بل تفاوتت نظراتهم إليه، فما يعده بعضهم غريباً، قد يكون عند غيره: غير غريب! ولذلك: لم تتفق كتب الغريب، فيما أوردته من ألفاظه، فبعضها: يذكر ألفاظا على أنها من الغريب، وبعضها: يُهمل بعض هذه الألفاظ، ويذكر ألفاظاً أخرى، هي - في رأي مصنفي تلك الكتب - من الغريب! وهذا مما يتفق مع ما قاله ابن الهائم : "لا شك أن الغريب يقابله المشهور، وهما أمران نسبيان، فربّ لفظ يكون غريباً عند شخص، مشهوراً عند آخر". وقد ظهر ذلك واضحاً، في الكتب الأوائل، التي ألفت في الغريب، حيث كان صغر حجمها، وقلة موادها، لافتاً للنظر! ويتجلى ذلك: في وصف حاجي خليفة (ت1067هـ) لكتاب أبي عبيدة (ت210هـ) في الغريب، حيث أخبر : أنه جمع كتاباً صغيراً، ثم استدرك قائلاً: "ولم تكن قلته لجهله بغيره، وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ بشيء لم يُسبق إليه يكون قليلاً ثم يكثر. والآخر: أن الناس كان فيهم - يومئذ- بقية، وعندهم معرفة، فلم يكن الجهل قد عمّ". ومن أجل ذلك أقول: إن حركة التأليف في غريب القرآن، قد تطورت تطوراً كبيراً، من بدايتها، إلى عصرنا الحاضر، وسيظهر هذا واضحاً جلياً، عندما نستعرض مؤلفات غريب القرآن. ولكن السمين الحلبي (ت756هـ) لم يفطن إلى هذه الحقيقة العلمية، التي تتعلق بتفاوت نظرات أهل الغريب، إلى الغريب، ولذلك نجده قد أخذ على الراغب الأصفهاني (ت في حدود: 425هـ) إغفاله بعض ألفاظ الغريب القرآني، في كتابه: (مفرادات ألفاظ القرآن) حيث قال (السمين الحلبي): (قد أغفل في كتابه ألفاظاً كثيرة، لم يتكلم عليها، ولا أشار في تصنيفه إليها، مع شدة الحاجة إلى معرفتها، وشرح معناها، ولغتها) ثم أورد بعض المواد التي أغفلها الأصفهاني. وأعتقد - في ضوء ما عرفنا، من تفاوت نظرات أهل الغريب إلى الغريب - أن ما أخذه السمين الحلبي، على الراغب الأصفهاني، ليس مأخذا يلتفت إليه، لأن المسافة الزمنية بينهما، أو بين عصريهما: طويلة، حيث تزيد على ثلاثة قرون، وهذه المسافة الزمنية: كفيلة بتغير اللغة، والعلم بها، حتى إنه ما كان معروفا في عصر الأصفهاني (القرن الخامس الهجري) ولا يحتاج إلى تفسير، أضحى مجهولاً في عصر السمين (القرن الثامن الهجري) ويحتاج إلى تفسير! |
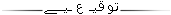  |
 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| سطور , في , كتاب |
| |