عن سعد رضي الله عنه:
أن رسول الله ï·؛ أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله ï·؛ رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: (أو مسلما). فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: (أو مسلما)، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله ï·؛ ، ثم قال: (يا سعد إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار). ثم عقد هذه الترجمة بابٌ ” إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة والترجمة ناقصة مقارنة بالأصل نقصًا يخلُّ بالمقصود ولا يتضح له مراد المترجم قال بابٌ “إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل “ لقول الله عز وجل : قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا غ– قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَظ°كِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ غ– وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا غڑ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله “إن الدين عند الله الإسلام”، وقوله “ومن يبتغَ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.” هذا كله كلام الإمام البخاري -رحمه الله- وبه ترجم هذا الباب فالترجمة التي أثبتت هنا ناقصه ونقصها يخلُّ بمقصود المترجم ومما نبهنا عليه أحد الأفاضل أن التراجم المثبتة هنا ليست للإمام الزبيدي -رحمه الله- وإنما أُلحقت فيما بعد وكانوا صنيعه أنه جرّد الأحاديث، وكلفت الأخ الذي نبه بذلك أن يكتب شيئًا حول ذلك للرجوع إلى النسخ الخطية والأصول ما يفيد حول ذلك ولعل هذا يتيسر قريبًا. ومما يؤكد ما أشار إليه أن التراجم فيها شيء من الخلل مثل هذا الاختصار المخلّ، وسبق أيضا أن مرّ معنا نظير له فيما تقدم، والشاهد أن هذه الترجمة لا يتضح بها المقصود إلا بقراءة تمام كلام المترجم للإمام البخاري -رحمه الله-. قال باب إذا لم يكن الإسلام علي الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، معنى هذا أنه قد يطلق الإسلام في بعض النصوص ويُراد به الاستسلام من الخوف، معنى ذلك أنه يأتي إطلاق الحقيقة في النصوص تارة على الحقيقة مثل الآية التي أشار إليها أن (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)، وأيضًا (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ) وتارة يطلق ويراد به الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام البعض، وهذا هو صنيع بعض أهل النفاق إسلامهم ظاهر وباطنهم النفاق والكفر باللّظ°ه -سبحانه وتعالى-. فإذنْ الإمام البخاري -رحمه الله- مراده هنا لم يكن الإسلام على الحقيقة بل كان على الاستسلام وخوفه من القتل. فهْم الإمام البخاري -رحمه الله- لهذه الآية على أن المراد بالإيمان هنا أصله، وأن المراد بالمعنيين بهذه الآية هم أهل النفاق حينما قالوا (آمنّا ). فنهاهم عن ذلك (قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَظ°كِن قُولُوا أَسْلَمْنَا) أي أخبروا بهذا الذي هو ظاهر منكم أما الإيمان ليس موجودًا عنكم، فيكون النفي هنا نفي لأصل الإيمان. وهذا القول يوافق فيه البخاري بعض السلف ومنهم محمد بن نصر المروزي وغيره والأظهر في معنى الآية أن الإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان وإنما هو كمالة الواجب وأن هنا المعنيين بكلام الآية ليس المنافقين وإنما هم أعراب حصل منهم الإسلام ولكن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم -أي لم يبلغوا درجة الإيمان ،أي لم يتمكن الإيمان من قلوبهم- فلما ادعوا إلى أنفسهم درجة من الدين عالية لم يبلغوها وهي درجة الإيمان نفى الإيمان عنهم. وهذا على قول من يفرّق بين الإيمان والإسلام، والإمام البخاري -رحمه الله- ومعه بعض السلف يرى أن الإسلام والإيمان شئ واحد، ولكن الصحيح أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في الذكر ، فالمراد بالإيمان الاعتقاد بالامور التي في القلب ومن المعلوم أن أمور الإيمان وأصوله وحقائقه الباطنة، و إذا تمكن الإيمان من القلب صَلُح الظاهر تِبعًا لذلك والإسلام غير ذلك .. [الأعمال الظاهرة] وهذا أيضًا مما يوضح المعلومة بين الإيمان والإسلام والمؤمن والمسلم إن كلَّ مؤمنٍ مسلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، لماذا ؟ لأن الإيمان مكانه القلب فإذا تمكّن الإيمان من القلب ورسخ فيه صلُحت الأعمال ولابد أن تَصلُح؛ لأن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب. من يُسلِم ويُعلن إسلامه وينطق الشهادتين ويقوم بأعمال الإسلام الظاهرة، قد تكون في هذه الأعمال مسلم ولكن لم يتحقق الإيمان ولم يتمكَّن من قلبه. وبعض السلف صوّر هذا الأمر بأنْ رسم دوائر رسم دائرة صغيرة ثم أوسع فأوسع، الدائرة الصغيرة للإحسان والأوسع للإيمان والأوسع منهما الإسلام، فالدائرة الصغيرة التي في الوسط تشملها دائرة الإسلام والإيمان، فليس كلُّ مؤمنٍ مسلم محسنًا، وإنما كلُّ محسنٍ مؤمنًا ومسلمًا، وكذلك في الإيمان والإسلام، فهذا مما يبيّن التفاوت. أورد الإمام البخاري -رحمه الله- شاهد لما قرره حديث سعد بن أبي الوقاص أن رسول الله -ï·؛- “أعْطَى رَهْطًا وسَعْدٌ جالِسٌ فيهم، قالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ منهمْ مَن لَمْ يُعْطِهِ، وهو أعْجَبُهُمْ إلَيَّ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما لكَ عن فُلانٍ؟ فَواللَّهِ إنِّي لأَراهُ مُؤْمِنًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أوْ مُسْلِمًا، قالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي ما أعْلَمُ منه، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما لكَ عن فُلانٍ؟ فَواللَّهِ إنِّي لأَراهُ مُؤْمِنًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أوْ مُسْلِمًا، قالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي ما عَلِمْتُ منه، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما لكَ عن فُلانٍ؟ فَواللَّهِ إنِّي لأَراهُ مُؤْمِنًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أوْ مُسْلِمًا، إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وغَيْرُهُ أحَبُّ إلَيَّ منه، خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ في النَّارِ علَى وجْهِهِ.” رهطًا أي رجل. “وهو أعْجَبُهُمْ إلَيَّ ” أي في تقديره أحق بأن يُعطى لِما تميّز به من خِصال وفضائل. “ما لكَ عن فُلانٍ؟” أي لماذا لم تعطه يا رسول الله -ï·؛-؟ أولًا بما أن الحديث ساقه الإمام البخاري فالحديث محمول عن الإمام البخاري أن الرجل منافق وأن الرسول -ï·؛- أثبت له الاستسلام الظاهر ونفى عنه أصل الدين أي الإيمان فالإيمان رُتبة أعلى فقوله قول سعد “فَواللَّهِ إنِّي لأَراهُ مُؤْمِنًا” الحكم علي الشخص ماذا ينبني على ماذا؟ على الشهادة بصلاح ظاهره وباطنه وتحقق الإيمان في قلبه وتمكّنه منه، وهذا لا اطلاع للناس عليه ولا حُكم لهم به، وهو بين الإنسان وبين ربه لكن بالنسبة للإسلام فهو ظاهر ولهذا النبي نبّه سعدًا في قوله “أوْ مُسْلِمًا”. “إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وغَيْرُهُ أحَبُّ إلَيَّ منه، خَشْيَةَ أنْ يُكَبَّ في النَّارِ علَى وجْهِهِ” يُكَبَّ مَن؟ الذي أعطاه الرسول -ï·؛- لو لم يعطه، فأعطاه مع أنه أقل منزلة من الآخر وأقل درجة من الآخر، ولكن أعطاه تأليفًا لقلبه وشفقةً عليه. فبيّن النبي -ï·؛- أن العطاء لا يرجع إلى المفاضلة في أمور الإيمان وخصاله وأعماله وإنما يرجع إلى هذه الأمور وهو أنه يعطي أقوامًا وغيرهم أَحَب إليه -ï·؛- لكنه يعطيهم خشية أن يكبهم اللّظ°ه في النار. إذنْ قوله “أحَبُّ إلَيَّ منه” هذه توضح أنه لا يحمل الرجل الذي ذُكر في الحديث على أنه منافق، وإنما يحمل على التنبيه على التفرقة بين هاتيْن الدرجتين الإسلام والإيمان والله اعلم |  الإهداءات
الإهداءات
 الإهداءات
الإهداءات
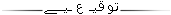






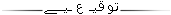


 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه